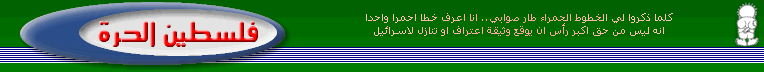الإطار التحليلي
المشهد الأول ... أكثر الاتفاقات سوء المشهد الثاني ...جنيف مكمل لخارطة الطريق المشهد الثالث : جنيف الأخطر في تاريخ الصراع المشهد الرابع : جنيف وقضية اللاجئين المشهد الخامس: جنيف وقضية اللاجئين المشهد السادس :جنيف وقضية الأسرى المشهد السابع : جنيف وقضية القدس المشهد الثامن :جنيف وقضية القدس(2) المشهد التاسع : سويسرا ووثيقة جنيف: تقويض سيادة القانون
المشهد الأول ... أكثر الاتفاقات سوء في منتجع سياحي أردني على شاطئ البحر الميت، وفي عزلة متعمدة عن وسائل الإعلام، انتهى الوزير ياسر عبدربه والجنرال عميرام متسناع ورفاقهما إلى التوقيع بالأحرف الأولى على إعلان مبادئ عرف باسم "اتفاق جنيف". وقد سارع شارون، ومنذ اللحظة الأولى لإذاعة نبأ "الاتفاق" إلى إدانة المشاركين في توقيعه من الصهاينة متهما إياهم بالتفريط بالمصلحة الصهيونية وتعريض مستقبل "إسرائيل" للخطر، وبما يقارب ذلك قال أيهود باراك، رئيس الوزراء العمالي السابق، الذي كتب في "يديعوت أحرونوت" يقول: إن "اتفاق جنيف تطور خطير يلقي بظلاله على مستقبل "إسرائيل"". يقرر باراك في مقاله بأن "الاتفاق" قد تم في إطار كل احباطات السنوات الثلاث الأخيرة من كلا قطبي الخريطة السياسية "الإسرائيلية"، وفي إيضاح ذلك كتب يقول: احباطات اليسار "الإسرائيلي" في ظل عدم وجود خطة سياسية نزيهة ومقبولة عالمياً تلقي الضوء على الأمل في نهاية نفق الدماء الذي فرض علينا من قبل العنف الفلسطيني، واحباط اليمين في ظل ال 850 قبراً المحفورة بعد الوعود الفارغة لجلب السلام والأمن وشعور قادته بأنهم يساقون في مسار "الدولتين لشعبين".
أما شيمون بيريز، زعيم حزب العمل، فلا يعتبر ما جرى توقيعه اتفاقاً وإنما هي "تفاهمات" غير رسمية، ومع ذلك فهو يحبذ إجراء مثل هذه "التفاهمات" عندما تكون حكومة شارون ممتنعة عن إجراء مفاوضات مع الطرف الفلسطيني، ولكنه في الوقت ذاته يعلن تحفظه على ما تضمنه "إعلان المبادئ" بشأن ما اعتبره تسليماً للسيادة في منطقة الحرم القدسي الشريف للفلسطينيين، مدعياً أن لديه "حلولاً أكثر إبداعاً"، ولقد أعرب عن معارضته تدخل قوات دولية، والحل المقترح بالنسبة لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، كما عارض الانتقال إلى الحل الدائم دفعة واحدة، مطالباً التوصل إلى تسوية على مراحل. وليس من شك أن ياسر عبدربه ورفاقه الذين وقعوا "اتفاق جنيف"، وكذلك رموز السلطة المؤيدين لهم سراً وعلانية، أسعد الناس بتنديد شارون وتحفظ بيريز وقول باراك. إذ يجدون في ذلك ما يساعد ليس فقط في تبرير مبادرتهم التي تعدد ناقدوها فلسطينياً وعربياً، وإنما أيضاً في تسويقها وترويجها باعتبارها إنجازاً واختراقاً لجبهة العدو، ويقيناً، إنه في واقع فلسطيني مأزوم وعربي فاقد المناعة، في حكم المؤكد أن يلقى موقعو ما يسمى "اتفاق جنيف" ومروجوه فلسطينياً وعربياً من يتقبلون دعاواهم ويرون في مبادرتهم "إنقاذ ما يمكن إنقاذه" ويتهمون معارضيها بالسلبية والعدمية واللاواقعية. فهل نحن حقاً أمام إنجاز تاريخي، واختراق فعلي لجبهة العدو الصهيوني، ومحاولة ناجحة في استغلال تناقضاته، وتوظيف مثمر لحصاد ثلاث سنوات من الانتفاضة؟ أم نحن أمام إعادة إنتاج اكثر سوءاً لاتفاق أوسلو وتداعياته المأساوية، وما حفل به العقد الماضي من تنازلات مجانية؟ وهل إن الوزير عبدربه ورفاقه تصرفوا من منطلق الإيمان بأنهم يمثلون شعباً مقاوماً هزت انتفاضته قناعات عدوه وإيمانه بثوابته وأساطيره، أم أنهم في الواقع العملي إنما كانوا بعضاً من نخبة تعيش مأزق وضوح فشل خيارها الاستراتيجي ورهانها على "الراعي" الأمريكي و"الأصدقاء الأوروبيين"، والشعور بتآكل ما تبقى لديها من رصيد وطني في مقابل التنامي المتصاعد للتيار المؤيد لخيار المقاومة وتعاظم دور رموزه الوطنية والإسلامية؟. وفضلاً عن ذلك فإن في الساحة، وبخاصة العربية، والفلسطينية منها على الأخص، من لم يقم أدنى اعتبار لما سمي "اتفاق جنيف"، ليس فقط لأنه لا يعدو كونه "تفاهمات" غير رسمية، كما قال محقاً شيمون بيريز، وإنما أيضاً لأنها صدرت عن نشطاء سياسيين ومثقفين ليس لأي منهم دور مؤثر في صناعة القرار الفلسطيني والصهيوني على السواء. وعليه فهل ما جرى لا يتجاوز كونه مجرد ندوة ساسة ومثقفين يحاولون تذكير الناس بوجودهم بعد أن سحب البساط من تحت أقدامهم إلى غير رجعة؟ أم أنه، كما يقرر الكاتب "الإسرائيلي" آري شبيط في "هآرتس" "وثيقة تاريخية تفرض حقيقة سياسية راسخة لا يمكن إلغاؤها أو تجاهلها" وأن "الطاقم "الإسرائيلي" الذي شارك في تلك المباحثات قد حقق إنجازاً دراماتيكياً"، وانتزع من الفلسطينيين اعترافات تاريخية غير مسبوقة؟ وهل ما صدر عن الملتقين "مبادرة" جديدة أم إعادة طرح لما تضمنته بعض المبادرات السابقة؟ وفي الإجابة عن التساؤلات والأسئلة السابقة: الحكم لما تضمنه "اتفاق جنيف"، كما ورد نصه الحرفي في صحيفة "معاريف"، ونقلته عنها الصحف العربية يوم 18 أكتوبر/تشرين الثاني الجاري، وأول ما نلاحظه أن مقدمة "الاتفاق" استهلت بالقول: "دولة "إسرائيل"، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وممثلو الشعب الفلسطيني، يعيدون تأكيد تصميمهم على وضع حد لأجيال من المواجهات للتعايش السلمي، والاحترام المتبادل، والأمن القائم على السلام العادل والشامل، والوصول إلى المصالحة التاريخية"، وهو قول يحاول أن يضفي على "التفاهمات" المتبادلة صفة "الاتفاق" الرسمي في مغالطة مفضوحة، إذ لم يكن المشاركون "الإسرائيليون" يمثلون دولتهم، ولا هم ينتمون في غالبيتهم لليكود ومن هم إلى يمينه المتحكمين في صناعة القرار الصهيوني، في حين أن منظمة التحرير الفلسطينية لم تستشر، بدليل رفض فاروق القدومي وأكثر من عضو في اللجنة التنفيذية البيان العتيد، أما الشعب الفلسطيني فإنه آخر من علم بما جرى التفاهم عليه، تماماً كما تمت الاستهانة به والاتفاق من وراء ظهره قبل عشر سنوات في أوسلو. وفي بيان ما اعتبره أطراف لقاء البحر الميت حدوداً دائمة بين الدولتين ورد ما نصه: "وفقاً لقراري الأمم المتحدة 242 و338 تقوم الحدود بين دولة فلسطين و"إسرائيل" على أساس خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 مع تعديلات متبادلة على أساس 1:1 كما تقرر في الخريطة المرفقة بالاتفاق"، وناهيك عن أن القوى العربية العامة والفلسطينية الخاصة، التي لما تزل ملتزمة بالثوابت الوطنية والقومية ما انفكت تعتبر كامل فلسطين من النهر إلى البحر أرضاً محتلة واجبة التحرير، فإن ما تضمنه "اتفاق جنيف" ينطوي على تزوير تاريخي، إذ نسب لقراري مجلس الأمن 242 و338 ما لم يرد له ذكر فيهما، فالقراران إنما اختصا بانسحاب "إسرائيل" إلى ما كانت عليه قواتها قبل عدوان يونيو/حزيران 1967. وليس في أي منهما ما يدل أدنى دلالة على إضفاء المشروعية الدولية على ما كانت تحتله خارج حدود قرار التقسيم رقم 181 لسنة 1947، وبالتالي فإن ما كان محتلاً خارج حدود التقسيم لا يزال يعتبر في نظر الشرعية الدولية أرضاً مغتصبة، والإجراءات الصهيونية فيها غير مشروعة. بدليل عدم الاعتراف الدولي بالقدس الغربية عاصمة لـ "إسرائيل" لكونها منطقة دولية محتلة بشكل غير مشروع. وتأسيساً على هذه الحقيقة لم تزل الولايات المتحدة، الحليف الاستراتيجي لـ"إسرائيل"، ممتنعة عن نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس. وإذا كان مراد أطراف لقاء البحر الميت تأسيس الدولتين على قاعدة الشرعية الدولية فقد كان حرياً بهم العودة للقرار المؤسس لذلك، والذي أقيمت استناداً إليه دولة "إسرائيل"، ألا وهو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947، وما أقدم عليه المشاركون الفلسطينيون في لقاء البحر الميت بقبولهم حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 حدوداً لدولة "إسرائيل" فأبسط ما يقال فيه إنه تفريط بحق دولي معترف به للشعب العربي الفلسطيني، وإهدار للحقوق الوطنية والقومية التي لم تزل غالبية شعبهم وأمتهم العربية تعتبرها حقوقاً تاريخية لا يجوز التفريط بها. فضلاً عن تجاهلهم أن شعبهم وجميع المسؤولين العرب رفضوا طوال سنوات 1949 1967 كل عروض التسوية على أساس الإقرار للعدو بما احتله خارج حدود التقسيم. أما المستوطنات فهي في نظر القانون الدولي غير مشروعة، إذ هي مقامة على أرض محتلة، وفي مخالفة صريحة للعديد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الأصوات، وبرغم ذلك تعامل معها ما يسمى "اتفاق جنيف" بنص ملتبس، بحيث يتاح لـ"إسرائيل" تفسيره في ضوء حقائق القوة وليس القانون الدولي، فالنص الخاص بالمستوطنات، ورد كما يلي: "حكومة "إسرائيل" تكون مسؤولة عن إعادة توطين مستوطنين يسكنون في الأرض الفلسطينية السيادية في "إسرائيل"، وتنتهي إعادة التوطين وفقاً لجدول زمني متفق عليه، ولحكومة فلسطين تكون الملكية المنفردة على كل الأراضي وكل المباني والمنشآت وغيرها من الأملاك التي تتبقى في المستوطنات"، ولنا على هذا النص أربع ملاحظات: أولاً، أسقط "ال" التعريف من كلمة المستوطنين، واكتفى بالقول توطين "مستوطنين" مبقياً لـ"إسرائيل" إمكانية القول بأن النص لا يلزمها بإعادة توطين جميع المستوطين، والشيء الواضح أن المشاركين الفلسطينيين لم يأخذوا في حسبانهم استغلال "إسرائيل" لغياب "ال" التعريف من كلمة "الأرض" في الصيغة الفرنسية لقرار مجلس الأمن رقم 242 لسنة 1967، ولم تزل ممتنعة عن الانسحاب من كامل الأرض التي احتلت يومذاك محتجة بذلك.
ثانياً، حدد الأرض الفلسطينية بأنها "الأرض السيادية"، مما يعني ضمناً أن هناك أرضاً لن تخضع للسيادة الفلسطينية، وبالتالي الاتفاق على عدم إعادة كامل الضفة الغربية وقطاع غزة، وعلى أن من المستوطنات ما يمكن أن تبقى على الأرض "غير السيادية"، وهذه ثغرة ثانية للتحايل على إعادة توطين جميع المستوطنين. ثالثاً، يقرر بأن تنتهي إعادة التوطين وفقاً لجدول زمني متفق عليه، دون أن يكون هذا الجدول من بين مرفقات الاتفاق، كما تم بالنسبة لخريطتي الحدود والقدس، الأمر الذي يعني دخول الفلسطينيين في مفاوضات ماراثونية حول ذلك، واضطرارهم لتقديم تنازلات إضافية تلتهم بعض ما أبقاه فريق أوسلو من حقوق لم يفرط بها بعد. رابعاً، ينص على أن تكون لحكومة فلسطين الأراضي والمباني والمنشآت وغيرها من الممتلكات التي تتبقى في المستوطنات، والنص يوحي بالملكية المجانية، في حين أن "الاتفاق" عندما يتناول التعويض عن أملاك اللاجئين الذين لن يسمح لهم بالعودة إلى أرض آبائهم وأجدادهم، ينص على أن تخصم من حصة "إسرائيل" في التعويضات قيمة المستوطنات التي يتم إخلاؤها والمنشآت المقامة عليها، في مخالفة واضحة لدلالة النص الخاص بالمستوطنات.
المشهد الثاني ...جنيف مكمل لخارطة الطريق تتجسّد نكبة فلسطين عام 1948 بعنصرين أساسيّين هما : تشريد شعب ،واغتصاب أرض،واللذين يكوّنان قطبي القضية الفلسطينية وجوهرها ،وفي الوقت نفسه فقد شكّل قرار الأمم المتّحدة رقم 194 سندا شرعيّا للمحافظة على حقّ اللاجئين الفلسطينيين بالعودةالى أرضهم ،والتعويض عن ممتلكاتهم ...هذا الحق الذي تؤكّده الجمعية العامّة لللأمم المتّحدة كل ّعام في دورتها العادية ... بينما سكت العالم عن اغتصاب الأرض الفلسطينية ،واستيطانها واستثمارها ،ومن هنا فإنّ حق العودة ترسّخ في الوجدان الفلسطيني ،وأبقى الحق الفلسطيني حيّا في النفوس يتوارثه الفلسطينيون جيلا بعد جيل ،وهو حق ثابت لايتأثّر بتقادم الزمن ...وبما أنّ تصفية القضية الفلسطينية أصبح هدفا ملحّا للتحالف الامبريالي – الصهيوني فقد استهدف هذا الحق عن طريق إجبارأصحابه على التخلّي عنه بمختلف طرق الضغط والاحتيال والإرهاب ،لأنّهم الجهة الوحيدة قانونا التي تمتلك ذلك ... ولهذا ازدهرت في السنوات الأخيرة التحرّكات واللقاءات والمشاريع التي تستهدف إزاحته من طريق استكمال تصفية القضية الفلسطينية بعد أن قطعت أشواطا متقدّمة خطيرة على هذا الطريق ،بدءا / بمؤتمر مدريد ،وأوسلو وتفريخاتها/ ووصولا الى / خارطة الطريق ،ثمّ وثيقة جنيف / ،وهذا كلّه عبر سلسلة ممهّدة من الحروب العدوانية التي ابتلعت أرضا عربية جديدة ،وشرّدت المزيد من سكّانها ...
وثيقة جنيف ملحق مكمّل لخارطة الطريق وبلورة ملموسة لمعظم جوانب الحلّ النهائي :
ولتوثيق حكمنا النهائي هذا لابدّ من إلقاء بعض الأضواء على محتوياتها وفق تسلسل ورودها :
1 – تقرّ الوثيقة عند تحديد هدف الاتفاق الدائم بأنّ: " تطبيق الاتفاق سيؤدّي إلى نهاية كل مطالب الطرفين ،النابعة من أحداث وقعت قبل التوقيع على الاتفاق ،وبهذا تنتهي إمكانية أن يطرح أيّ من الطرفين مطالب تعود الى عصر ما قبل التوقيع ."
وهذا النصّ إقرار و تأكيد على التصفية الشاملة للقضية الفلسطينية ، وشطب كامل لجميع ثوابت الشعب الفلسطيني ، وإبطال لكافّة القرارات الدولية التي أنصفت الشعب الفلسطيني بعض الشيء ،والتخلّي عن الحقوق الفلسطينية ووضعها تحت رحمة الحكومات الاسرائيلية. 2 – تنصّ الوثيقة عند تحديد العلاقات بين الطرفين على أنّ : " دولة اسرائيل تعترف بدولة فلسطين فور قيامها ،دولةفلسطين تعترف فورا بدولة اسرائيل " وهنا يبرز بوضوح عدم النكافؤ في الاعتراف المتبادل ،ففي الوقت الذي يطلب فيه من دولة فلسطين الاعتراف الفوري ( بدولة اسرائيل ) / وهنا حسب تقديري المقصود هو اعتراف فوري من الحكومة الفلسطينية / باسرائيل / ، بينما يتأجّل الاعتراف الاسرائيلي بدولة فلسطين حتى قيامها ...
وتشير الوثيقة في مجال العلاقات بين الطرفين على أنّ : " اسرائيل وفلسطين تعملان معا ، وكلّ على حدة مع محافل مختلفة في المنطقة لتطوير التعاون الإقليمي " . وهنا نلاحظ خصوصية العلاقة بين الدولة الفلسطينية المنتظرة والكيان الاسرائيلي من خلال العمل معا في الوطن العربي ،واستخدام الفلسطينيين بشكل مقنّن كأداة بيد الحكومات الاسرائيلية بهدف التغلغل في المنطقة بكافّة المجالات تحت يافطة : تطوير التعاون الإقليمي ... 3 – وفي مجال المستوطنات تنصّ الوثيقة :" تكون حكومة اسرائيل مسؤولة عن إعادة توطين مستوطنين يسكنون في الأرض الفلسطينية السيادية في اسرائيل ،وتنتهي إعادة التوطين وفقا لجدول زمني متّفق عليه ." وهنا نلاحظ إصرار الطرف الاسرائيلي على التلاعب ثانية بمفهوم أل التعريف ، وبتعويم الالتزامات الاسرائيلية من خلال عبارة "إعادة مسنوطنين " وترك المجال مفتوحا (لاسرائيل) ولإرادة حكومتها في تحديد ذلك مستقبلا ،كما يفسح الباب واسعا لتفسيرات متناقضة حول عدد المستوطنين المشمولين بهذا البند قد تعيد خلط الأوراق ثانية ، والعودة الى نقطة الصفر ... 4 – عند التحدّث عن : "خصائص أمن الدولة الفلسطينية " تشير الوثيقة على أنّ :" فلسطين تكون دولة مجرّدة من السلاح ، مع قوّة أمن قويّة . القيود على السلاح الذي يمكن شراؤه أو استخدامه من قوة الأمن الفلسطينية او انتاجه في فلسطين يفصّل في ملحق بالانفاق . ولايمكن لأيّ جهة شخصيّة أو منظّمة في فلسطين باستثناء قوّة الأمن الفلسطينية أن تشتري ،تحمل ،أو تستخدم السلاح باستثناء ذلك الموفّر وفقا للقانون ." يعتبر هذا البند انتقاصا مفضوحا لسيادة الدولة الفلسطينية من خلال تجريدهامن السلاح ،وحرمانها من تشكيل جيش وطني ، وتحديد نوع سلاحها من قبل المحتّل ،كما تحرم أي مواطن فلسطيني من حمل سلاح ، ولو كان مسدّسا ، وحصره قانونا بعناصر الأمن الفلسطيني ... وبما أنّ الدولة الفلسطينية ستكون مجرّدة من السلاح فهذا يعني من جهة أخرى أنّها ستكون عاجزة عن حماية حدودها ،وبالتالي تبقى ( اسرائيل ) هي المخوّلة بذلك ...بينما لم تشر الوثيقة الى أسلحة المستوطنين الذين سيبقون في إطار السيادة الفلسطينية ،وهذا يعتبر قبولا ضمنيا بإبقاءالوضع الراهن القائم حول هذه النقطة ... 5 – ينصّ بند ( الإرهاب ) على أن :" يبزل الطرفان جهودا مشتركة ضدّ كل مظاهر العنف والاهاب ،وتتضمّن هذه الجهود منع أعمال كهذه ومطاردة منفّذيها . وتتشكل لجنة ثلاثية الأطراف من الطرفين والولايات المتحدة لتأكيد تطبيق هذا البند " وهذا تأكيد على التصفية الشاملة للانتفاضة ،ونزع أسلحة فصائلها ، وملاحقة العناصر التي تحمل السلاح ...أمّا بخصوص تشكيل اللجنة الثلاثية لمرابقة تطبيق هذا البند فهو استبعاد لأطراف دولية أقلّ انحيازا (لاسرائيل )مثل : الاتحاد الأوربي،والاتحاد الروسي ،والأمم المتحدة ، والتسليم بهيمنة أمريكية – اسرائيلية على هذه اللجنة ، وهذا ينسجم مع أحد شروط /شارون/ المتعلّقة بخارطة الطريق .... 6 –وفي بند: "قوّة متعددة الجنسيات ينصّ : " لتنفيذ الوظائف المفصّلة في الاتفاق تنتشر القوّة متعددة الجنسيات في دولة فلسطين " . وهنا يبرز ثانية عدم التكافؤ بين طرفي الاتفاق من حيث الاقتصار على نشر القوات المتعددة الجنسيات فوق الأرض الفلسطينية فقط دون غيرها... 7 – تنصّ الوثيقة في بند الإخلاء على تنفيذ الانسحاب العسكري والأمني الاسرائيلي من أراضي دولة فلسطين على مرحلتين : " المرحلة الأولى تتضمّن مناطق دولة فلسطين كما تصف الخارطة ،وتستكمل في غضون تسعة أشهر ، وتتضمّن المرحلة الثانية والثالثة باقي الأراضي الإقليمية لدولة فلسطين ،وتستكمل في غضون 21 شهرا من نهاية المرحلة الأولى تحافظ اسرائيل على وجود عسكري مقلّص في غور الأردن تحت صلاحية القوّة متعددة الجنسيات وبالخضوع لها على مدى 36 شهرا أخرى ،هذه الفترة الزمنية يفحصها الطرفان مجددا في حالة تطورات إقليمية ذات صلة ، ويمكن أن تمرّ بتعديلات بمافقة الطرفين ." - إنّ هذا البند يقرّ بتواجذ اسرائيلي فوق الأرض الفلسطينية لفترة زمنية مجموعها 66 شهرا ،أي خمس سنوات ونصف ،مع إبقاء الباب مفتوحا مستقبلا للتمديد ... وهذا انتقاص آخر لسيادة الدولة الفلسطينية ، واستمرار الهيمنة الاسرائيلية ...
8 – تنصّ الوثيقة على : " حق اسرائيل بالاحتفاظ بمحطات إنذار مبكّر في شمالي ووسط الضفة الغربية وذلك لمدّة عشر سنوات خاضعة للبحث بعد ذلك بموافقة الطرفين ". أي أنّها قابلة للتمديد بعد هذه المدة الطويلة ،وخضوعها للبحث والموافقة على انتهاء هذا الحق سيكون عمليا خاضعا للمشيئة الاسرائيلية ،وهذا انتقاص واضح للسيادة الفلسطينية ... 9 – سمحت الوثيقة لسلاح الجو الاسرائيلي باستخدام المجال الجوّي الفلسطيني بهدف التدريب ولمدّة عشر سنوات قابلة للتفاوض والتمديد ... كما حدّدت مهمة الاشراف على معابر الحدود للدولة الفلسطينية من قبل طواقم مشتركة من قوة الأمن الفلسطينية وقوة أمن متعددة الجنسيات ...مع تواجد اسرائيلي أمني غير منظور للعين في قاعات المسافرين والأمتعة لمدّة 30 شهرا ...وهكذا تتالت انتقاصات السيادة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية ،وتعددت أشكال الهيمنة الاسرائيلية فوقها ، وإبقاء الباب مفتوحا لاستمرارها مستقبلا ... 10 – بالرغم من عدم نشر الخرائط التي تحدّد السيادة على القدس الشرقية إلاّ أنّ المعلن في هذا المجال يؤكّد تنازل الفلسطينيين عن حائط البراق ( لاسرائيل ) وعن نفق الحائط الغربي ،ووضع نظام دولي للإشراف على نطاق الحرم ، كما أبقت المقبرة اليهودية في جبل الزيتون تحت السيطرة الاسرائيلية ، ووضعت ترتيبات الوصول إليها ،كما أشارت بشكل عام وعائم الى وضع البلدة القديمة والترتيبات الخاصة فيها ،وعموما فإن القاعدة التي اعتمدت هي : "مامع العرب للعرب ،وما مع اليهود لليهود " ،وبذلك لم يبق للفلسطينيين سوى حوالي 15 بالمائة من مساحة كامل مدينة القدس ... وبذلك يكون هذا الاتفاق قد خرق ثابتا فلسطينيا آخر يتعلّق بعودة القدس الشرقية للفلسطينيين ،وتنازلا صريحا عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تعتبر إجراءات (اسرائيل) في القدس واستيطانها باطلة ، ومن أهمّها : القرار 252تاريخ 21/5/968 ، والقرار 267 تاريخ 3/7 /969، والقرار 271 تاريخ 15/ 9/ 969 ، والقرار 298 تاريخ 25/9/ 971 ،والقرار 476 تاريخ 30 /6/980 ، والقرار 478 تاريخ 20/8/980 .....الخ والتي لايمكن تعويضها في ظل موازين القوى الدولبة الراهنة .... 11 – حول اللاجئين : تعتبر قضية الللاجئين الفلسطينيين المسألة الأهم والأخطر التي عالجتها وثيقة جنيف ، وقد أشارت إلى أنّ قرار الأمم المتحدة 194 ،وقرار مجلس الأمن 242 ،ومبادرة السلام العربية التعلّقة بحقوق اللاجئين هي الأساس لحلّ مواضيع اللاجئين المتّفق عليها ، وما الإشارة الى تلك القرارات إلاّ نوعا من التخدير والتحايل وذرّ الرماد في العيون لتضليل الفلسطينيين وغيرهم من العرب ، والتستر على جريمة التخلّي عن حق العودة ،لأنّ مضمون الاتفاق يتناقض مع تلك القرارات وينفيها ،حيث أقرّت الوثيقة بأنّ: هذا الاتفاق هو حلّ كامل ودائم لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين ،لايجب طرح مطالب أخرى غير تلك المتعلّقة بتطبيق هذا الاتفاق ." وفيمايلي أهمّ النقاط الواردة في الوثيقة حول اللاجئين :
التعويضات : " اللاجئون يستحقوّن تعويضا على مكانتهم كلاجىء،وعلى فقدانهم للأملاك وهذا الأمر لا يمسّ بالحقوق المتعلّقة بمكان السكن الدائم للاجىء ""... وقد حدّدت الوثيقة الأسس التي سيتم استنادا اليها تقدير التعويضات ...
اختيار مكان سكن دائم : خيارات مكان السكن الدائم التي يمكن من خلالها أن يختار اللاجىء ستكون على النحو التالي :
" 1- دولة فلسطين 2 – دول طرف ثالث خارج فلسطين ( وخارج مناطق إقامتهم الحالية) . 3 – دولة اسرائيل ، ولكن سيكون خاضعا للتفكّر السيادي ولإسرائيل ، ويتناسب والعدد الذي ستنقله اسرائيل الى اللجنة الدولية . 4- الدول المضيفة للاجئين الآن ،وهذا الخيار سيكون بقوّة التفكّر السيادي للدول المضيفة ، وتنتهي مكانة الفلسطيني اللاجىء مع تحقق مكان السكن الدائم ، ويتقرّر من قبل اللجنة الدولية ، وفي الوقت نفسه فإن هذا الاتفاق هو حلّ كامل ودائم لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين لايجب طرح مطالب أخرى غير تلك المتعلّقة بتطبيق هذا الاتفاق ، كما سيتم حلّ وكالة غوث اللاجئين لاحقا "... وبذلك يكون اللاجئ الفلسطيني من الناحية العملية مالكا لحق العودة الى الدولة الفلسطينية في الضفة والقطاع /بعد عملية تبادل الأراضي بين الطرفين / ،أمّا عودته الى أرضه في فلسطين المحتلة عام 1948 ،فهي مرهونة بإرادة الحكومة الاسرائيلية ، والموقف الاسرائيلي معروف وواضح حيال هذا الأمر ، وهو الرفض القاطع للعودة ،إلاّ في إطار ضيّق جدا قد يشمل بعض كبار السنّ تحت غطاء لمّ شمل العائلات الفلسطينية ،وذلك بهدف ستر عورة المفاوض الفلسطيني ،وتغطية تنازله عن هذا الحق المقدّس ... وهنا نلاحظ كيف فرّغت الوثيقة حق العودة إلى الأرض والديار، مع التعويض عن الممتلكات واستغلالها منذ التشريد عام 1948 ، وأصبح عبارة عن الحق في اختيار مكان سكن دائم أي نوع من أشكال التهجير أو الهجرة الجديدة ، أو القبول بمكان السكن ا لحالي – اذا تيسّر – مع التخلّي عن حق العودة بشكل نهائي .. 12 – حول السجناء والمعتقلين : عاملت وثيقة جنيف المعتقلين على الشكل التالي : " الصنف :ا – ويشمل كل الأشخاص الذين سجنوا قبل بدء تطبيق إعلان المبادئ في 4/5/ 994 ، والمعتقلين الإداريين والقاصرين وكذا النساء والسجناء المرضى ، يفرج عنهم فورا مع دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ . الصنف:ب – كل السجناء الذين سجنوا بعد 4/5/994 ، وقبل التوقيع على هذا الاتفاق يفرج عنهم في موعد لايتجاوز 18 شهرا بعد موعد دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ، ويستثنى من ذلك اولئك المشار إليهم في الصنف ج .. الصنف : ج – حالات استثنائية – أشخاص أسماؤهم مفصّلة في ملحق الاتفاق ، يفرج عنهم في غضون ثلاثين شهرا بعد نهاية التطبيق الكامل للجوانب الإقليمية من هذا الاتفاق". إنّ هذا التصنيف يجسّد النهج الصهيوني الثابت حيال المعتقلين سواء أكان المفاو ض يمينيا أم يساريّا ، ففي الوقت الذي تدعو فيه الوثيقة الى مصالحة تاريخية بين الطرفين : الفلسطيني والاسرائيلي ، وإلى التعايش السلمي والاحترام المتبادل ، والأمن القائم على السلام العادل والشامل فإنّ المفاوض الاسرائيلي – وحتى اليساري – يبدو عاجزا عن الخروج من قمقمه الصهيوني والثأري والانتقامي من مناضلي أبناء الشعب الفلسطيني الذين يتّهمهم بتلويث أيديهم بدم الشعب اليهودي ، بينما يغض الطرف ويتسامح ويبرّر الجرائم الدموية التي ارتكبتها القوات الاسرائيلية في عهد /شارون/ ومن سبقوه ... كما أنّ الطرف الفلسطيني يبدو مدمنا على ارتكاب الأخطاء بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين عند التوقيع على / أوسلو / وما تبعها من اتفاقات ، ومتجاهلا هؤلاء الصفوة المختارة المناضلة من أبناء الشعب الفلسطيني التي دافعت وضحّت من أجل حرية الشعب الفلسطيني وحقوقه ،وتحرير أرضه وكرامته وكرامة الأمة العربية جمعاء...فالوثيقة تجعل السجناء المشمولين في التصنيف : ج تحت رحمة الانتهاء من التطبيق الكامل للجوانب الإقليمية من هذا الاتفاق ، هذه الجوانب المطّاطة والعائمة والمجهولة ، والتي لايستطيع أيّ من المفاوضين تفسيرها بشكل متطابق مع تفسير الآخر ، فالاتفاق بحاجة الى حوالي 6 سنوات حتى يستكمل مراحله وآجاله اذا سارت الأمور على أحسن ما يرام دون أيّ عراقيل أو تأخير أو تأجيل ، وكيف الأمر اذا كان مفهوم هذا الشرط الجائر يرتبط مع التوقيع على اتفاقات مع دول عربية أخرى قريبة أو بعيدة عن فلسطين ، والانتهاء من تنفيذها ...؟ 13 – أقرّت الوثيقة في ملاحظتها الأخيرة على :" إنّ الاتفاق لم ينته بعد ، حيث أنّ مواضيع المياه والعلاقات الاقتصادية والجهاز القضائي وعشرات الملاحق ،بعضها جوهري’ جدّا لم تكتب بعد ." أي أنّ أمورا كثيرة وخاصة موضوع المياه سيحتاج الى مفاوضات طويلة ، وقد تثير الكثير من الخلافات التي ربّما تعصف بالاتفاق كلّه .. هذا مع العلم أنّ جوانب كثيرة في الاتفاق لاتزال غير معروفة ، وربّما متستّر عليها في 53 ملحق ، ولاشكّ فيه أنّ المخفي هو الأعظم والأخطر ... ملاحظات واستنتاجات عامّة : إضافة إلى الملاحظات التي تمّ ذكرها عند استعراض بنود الاتفاق فإنّنا نرصد مايلي :
1- وجود عدم تكافؤ بين المتفاوضين والموقّعين على وثيقة جنيف ، ففي الوقت الذي كان فيه المفاوض الاسرائيلي من (اليسار) المعارض في (اسرائيل) ،وليس له أيّة صفة رسمية الآن في الكيان الصهيوني ، فإنّ المفاوض الفلسطيني كان من العناصر المشاركة في السلطة الفلسطينية أو المحسوبة عليها تحت يافطة أنّهم أقدموا على هذه الخطوة بتصرّف شخصي ، وهذا التبرير لايمكن يصدّقه أيّ مراقب سياسي ، فلايجرؤ ياسر عبدربّه ،وأمثاله أن يشاركوا ويوقّعوا على وثيقة بمثل هذه الخطورة والتفريط لولا حصولهم على ضوء أخضر من /أبوعمّار/ شخصيّا ،كما أنّ وفدا رسميّا برئاسة /جبرائيل رجّوب / عضو مجلس الأمن القومي الفلسطيني ،وعضويّة /قدّورة فارس/ وزير الدولة في الحكومة الراهنة وآخرون ... حضروا ( زفّة) التوقيع على وثيقة جنيف ...
2- إنّ هذا النهج الفلسطيني الرسمي هو سابق لوثيقة جنيف ،فقد سبق للدكتور: سرّي نسيبة الذي كان مسؤولا عن ملفّ القدس ( بمرتبة وزير) بالتوقيع على وثيقة مع /إيلون / محورها وجورها يقوم على التفريط بحق العودة ، هذا إضافة الى حضور مسؤولين فلسطينيين في ندوات ولقاءات في أوربا أمثال : ياسر عبدربّه ،وزياد أبوزياد وهشام عبد الرازق ...وغيرهم ، وكانوا يطمئنون الحضور بأنّ حق العودة ليس عقبة كأداء في وجه المفاوضات والاتفاقات ، وإنّما يمكن إيجاد حلّ له ...بينما نشاهد في الطرف الآخر أنّ /شارون/ وحكومته قد رفضوا وثيقة جنيف بالرغم من سوئها فلسطينيا .. وعلى كل حال فإذا كان الطرف الاسرائيلي الذي يمثّل اليسار الاسرائيلي ، وربّما أقصاه ، وحركات /السلام الآن / ، وبعد مخاض طويل لم يقبل بأكثر من هذا السقف المتدنّي من الحقوق الفلسطينية ،والمرفوض من الجماهير الفلسطينية والعربية ،فكيف الحال اذا كان المفاوض هو /شارون /وحلفاؤه من اليمين الصهيوني المتطرف ،وهذا يقدّم الدليل والبرهان على الطرق المسدودة أمام أيّة مفاوضات مستقبلية مع العدو الاسرائيلي في حال تمسّك الطرف الفلسطيني ولو بالحدود الدنبا لحقوق الشعب الفلسطيني ،كما يلقي الضوء على الاتجاهات والمسارات الخطرة للتنازلات المحتملة للسلطة الفلسطينية اذا سارت المفاوضات تحت خيمة /خارطة الطريق / حتى النهاية ... 3- يعترف الطرفان الموقّعان على /وثيقة جنيف / بأنّها غير رسمية وليست ملزمة ،ولابدّمن إعادة طرحها على الجهات الفلسطينية والاسرائيلية المسؤولة ،وحسب تقديرنا أنّها ستكون ورقة عمل للتفاوض مستقبلا كملحق / لخارطة الطريق / من أجل معالجة مسائل الحل النهائي ،وفي هذه الحالة فإنّ سقفها المتدنّي سيزداد هبوطا وخرقا للثوابت الفلسطينية ... وهذا الخطأ التفاوضي الفادح الذي يقع فيه الطرف الفلسطيني يعود ليكرره ثانية وثالثة ... إذ يأتي للتفاوض وهو يقبل بالحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني ،ثم يقبل بما دونه على طاولة المفاوضات وفي الكواليس ، بينما عدوّنا الاسرائيلي يطرح دائما السقف الأعلى من شروطه ومطامعه ،وعند التفاوض يحصل على مبتغاه الحقيقي من التفاوض دون نقصان ... وكلّنا يتذكّر شروط /شارون/ وحكومته على / خارطة الطريق / ( 14 شرطا) ،والقبول الفلسطيني دون شروط ، وحتى قبل أن تصدر بصيغتها النهائية ......
وهنا لابدّ من الإشارة الى أنّ بعض الفلسطينيين والعرب يفلسف الأمور ويقول : إنّ التوقيع على اتفاقية جنيف هو تكتيك سياسي لإحراج /شارون/ وحكومته ، وتبييض صفحة / أبو عمّار / وحكومته لدى أمريكا وبقيّة الغرب ،وهم يدركون أولايدركون أنّ الألاعيب والتكتيكات السياسية التي تمسّ الثوابت والأهداف الفلسطينية الاستراتيجية جريمة لاتغتفر ،لأنّ أيّ خطأ تكتيكي فيها سيشكّل سابقة سياسية مسلّم بها عند التفاوض مستقبلا بدون ثمن ، وبمثابة جرعة تفريط جديدة رسميّا وشعبيا على طريق ليس له نهاية من التنازلات ....
4 – إنّ السلطة الفلسطينية تتحمّل المسؤولية السياسية والمعنوية عمّا نجم وينجم من تبعات سلبية عن / وثيقة جنيف / ،وإلاّ من المفروض والواجب محاسبة ومحاكمة الوفد الفلسطيني الذي فاوض ووقّع عليها ،لأنّه لايمتلك الحق بالتصرّف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين ،أو ينتقص من الثوابت الفلسطينية الأخرى ، باعتبارها مقدّسة لايحق لأحد التفريط بها مهما كان .... 5 – في الوقت الذي تغوص فيه السلطة في وثيقة جنيف وخارطة الطريق ، وتتلهّى به ، وتلهّي شعبها فإنّ /شارون/ يرسم حدود الكيان الصهيوني وفق خطته الخاصة بجدار الفصل العنصري دون اكتراث من أحد ،كما يستمر في إرهابه داخل الضفة والقطاع ،ويصعّد من جرائمه ضدّ أبناء الشعب الفلسطيني ، ويتنصّل من كلّ اتفاقات ومواثيق وقرارات دولية سابقة ، ولذلك فإنّ أيّة مراهنة على استمرار التفاوض معه على /خارطة الطريق/ من أجل الحصول على حقوق الشعب الفلسطيني ولو بحدودها الدنيا ليس إلاّ وهما ، وسرابا مخادعا ، ولن يقود إلاّ الى المزيد من الكوارث والمآسي
المشهد الثالث : جنيف الأخطر في تاريخ الصراع
تشكل وثيقة جنيف نقطة تحول أساسية في الصراع العربي الصهيوني ، لا تقل بنتائجها عن قرار الاعتراف بدولة الكيان الصهيوني ، وإنهاء حالة الحرب معها ، وإذا كان الاعتراف بالكيان الصهيوني قد أسس لشرعنة الاحتلال واغتصاب فلسطين واعتبار القوة مصدراً للحقوق , فإن وثيقة جنيف أضافت بعداً جديداً عبر تخليها عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي التي طرودا منها , حيث أن المسألة تتجاوز مسألة الحقوق الفردية لأولئك المهجرين وعائلاتهم لتقود إلى مجموعة من المفاهيم والقيم في مقدمتها : 1)- إلغاء دور القرارات الدولية كمصدر للمشروعية في العلاقات الدولية , من خلال تجاوز القرار رقم 191 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والقاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم والتعويض عليهم بشكل عادل . وهذا الموقف ( يلغي إمكانية الاعتماد على الأمم المتحدة ) كهيئة دولية في النزاعات الإقليمية , وخصوصاً بالنسبة للقرارات المتعلقة بالكيان الصهيوني هذا الإلغاء والتجاهل لا تتوقف آثاره عند الواقع الراهن بل تمتد آثاره إلى المستقبل , حيث تبطل إمكانية الاعتماد على الأمم المتحدة من أجل ضمان أي اتفاق مع الكيان الصهيوني , وتبقى تلك الاتفاقات خاضعة للمزاج والدارة المتبدلة لقادة العدو الصهيوني . 2)- تكريس المبدأ الذي يعتبر ( الأراضي العربية المحتلة بعد عام 1967 ) أراض متنازع عليها بين العرب والصهاينة . ونفي صفة الاحتلال عنها , بما يفرضه هذا المبدأ من تبعات متعددة , لا تتوقف عند تجاهل الشرعية الدولية . والتخلي عما ساندنا به الأشقاء والشعوب من مواقف داعمة لقفيتنا , وهو ما يبرر انصراف هؤلاء عنا والاهتمام بمصالحهم المباشرة والآتية بل تصل حدودها إلى اعتبار المقاومة ضد الوجود الصهيوني نوعاً من أعمال العنف غير المشروع , حيث أن المقاومة المشروعة هي تلك التي تقف في وجه الاحتلال , لا في مواجهة النزاعات التي يجب أن تحل بالوسائل السليمة . 3)- مصادرة إمكانية المطالبة بالحقوق العربية مستقبلاً , وإلغاء مقولة الصراع التاريخي والاستراتيجي بين العرب والصهاينة من خلال إزالة أهم ورقة في إمكانية خلق مصادرة قوة مستقبيلة داخل الكيان الصهيوني قادرة على توليد مفاعيل تساعد على مقاومته وإنهاء مشروعه السرطاني , حيث أن حق العودة بما يمثله من عودة ملايين اللاجئين إلى داخل الكيان الصهيوني سيساعد على تفجير الكيان من داخله وتغيير هويته السكانية وإلغاء الهوية اليهودية لهذا الكيان مما يعني على المدى الطويل وفي ظل حصار عربي تذويب الحملة الصهيونية في المنطقة . على ضوء ما تحمله هذه ( المبادرة ) من تعطيل لدينا ميكية الصراع , ونفسه تطرح مجموعة من التساؤلات عن مشروعية هذه المبادرة , وهل يمكن اعتبارها مجرد وجهة نظر أواجهها داخل الساحة الفلسطينية . أولاً : من المؤكد أن هذه المبادرة لقيت معارضة واضحة من قوى أساسية في المجتمع الفلسطيني داخل الضفة وقطاع غزة شملت حركات المقاومة بما فيها تيارات أساسية في حركة فتح , أي أنها لا تملك تأييد الأغلبية في الشارع الفلسطيني الداخلية , وإنما هي نتاج للسلطة المحلية , التي وافقت عليها وأرسلت ممثلين عنها لدعمها . ثانياً : أن السلطة الفلسطينية لا تحظى من الناحية القانونية بحق تمثيل الفلسطيني في خارج فلسطين الذي لم يشاركوا أصلاً في اختيارها ( بعيداً عن مشروعية الاختيار الذي جرى في ظل الاحتلال ) . وبالتالي لا تملك تفويضاً يؤهلها للحديث عنهم , وخصوصاً أن الأغلبية الساحقة من هؤلاء أعلنت مواقف رافضة للمبادرة بما فيها التيارات المحسوبة على حركة فتح . ثالثاً : أن حق العودة حق جماعي وفردي , وبالتالي لا تملك أية سلطة التخلي عنه لأنه يمس الحقوق المشروعة للأفراد والمكرسة بالمواثيق الدولية . رابعاً : ومن منطق تفاوضي بحت تظهر المبادرة مجموعة من الأخطاء الكبيرة والقائلة , منها 1- أن القيادة الفلسطينية أبدت تأييدها للمبادرة وموافقتها الصمتية عليها , على عكس القيادة الصهيونية الرسمية , وهو ما يضع المفاوض الفلسطيني الرسمي في موقف ضعيف حيث هو ملزم بما اعتبره حلول وسط بينما سيجعل المفاوض الصهيوني هذه التوافقة هي سقف المطالبة العربية , لتكون مدخلاً لحلول وسط جديدة تقل عنها , وهو أسلوب اتبع بشكل نمطي في جميع المفاوضات الفلسطينية ( الإسرائيلية ) 2- تم تصوير أن مبادرة جنيف ( من قبل الجانب الفلسطيني ) بأنها لم تتنازل عن حق العودة في محاولة لخداع الشارع الفلسطيني وأن جل ما فعلته هو وضع هذا الحق لمفاوضات تتم بين الطرفين وتحظى باتفاقهما . 3- تم تصوير المبادرة أنها قدمت حلاً وسطاً حيث قام الجانب الصهيوني بالتنازل عن القدس مقابل التنازل عن حق العودة , وهو تصوير خاطئ , حيث أن الجانب الصهيوني لم يتنازل عن القدس , ولم يعتبرها عاصمة موحدة لدولتين , وإنما تنازل الجانب الفلسطيني عن أحياء واسعة من القدس الشرقية مثل حي المغاربة وحائط البراق وحي اللاتين وتم توزيع السيادة ( بشكل مشترك ) على ما تبقى من أحياء القدس الشرقية , بينما بقيت القدس الغريبة بالكامل تحت السيارة الصهيونية. 4- تضمنت المبادرة الموافقة على ضم " المستعمرات الصهيونية الكبرى " إلى الكيان الصهيوني , وسلخها عن أراضي الضفة الغربية . 5- لم تتحدث عن السور الانعزالي الذي يحول مناطق الضفة الغربية إلى سجن كبير للفلسطينيين . 6- لم تبت بمصير الأسرى الفلسطينيين وخصوصاً رجال المقاومة الذي تقول " إسرائيل " أن أياديهم ملطخة بدماء اليهود ) 7- ولم تتحدث عن الطبيعة الدينية للكيان الصهيوني , والتي تتنافى مع تكوين الدول الوطنية الحديثة وتكرس مبدأ العنصرية البغيض . لقد كان من الأجدى بالمفاوض الفلسطيني أن يجعل سقف تحركه السياسي في هذه المرحلة فرض تفاهم لإخراج المدينين من العنف على غرار تفاهم نيسان في لبنان الذي مهد فيما بعد الانسحاب إسرائيلي غير مشروط من الجنوب اللبناني , بدل الدخول في مفاوضات بظروف غير مواتية للجانب الفلسطيني
المشهد الرابع : جنيف وقضية اللاجئين
يكاد الفلسطينيون الرسميون ينسون تماماً أن هناك مليون عربي فلسطيني في الأرض المحتلة عام 1948 والتي تسمى الآن "إسرائيل". وهذا هو شأن أغلب وسائل الإعلام العربية التي لا تنساهم أو تتناسهم فقط وإنما تسميهم "عرب إسرائيل". اتفاق أوسلو وما تمخض عنه من اتفاقيات وكذلك وثيقة جنيف لا تتطرق إلى هؤلاء المليون الذين يعانون من الاحتلال "الإسرائيلي" منذ عام 1948، أي بمدة زمنية أكثر من مدة احتلال الضفة الغربية والجولان وغزة بسبعة عشر عاماً.
قامت منظمة التحرير الفلسطينية أساساً من أجل تحرير فلسطين المحتلة/48 وتخليص من بقي من الفلسطينيين وإعادة اللاجئين، وهكذا كان الأمر بالنسبة لحركة فتح ومعظم الأنظمة العربية. لقد حصل التراجع في المواقف على مختلف الصعد، لكن التراجع فيما يخص فلسطينيي الوطن المحتل 48 كان تاماً إلى درجة أن أحداً غير بعضهم لا يهتم بتاتاً بمستقبلهم ولا بأي ترتيبات تساعدهم على البقاء ككل متكامل تحت الحكم "الإسرائيلي". تتعامل مختلف الأوساط الرسمية الفلسطينية والعربية معهم وكأنهم في العدم.
وثيقة جنيف لم تتجاهل هؤلاء المليون فحسب وإنما أكدت بما لا يدع مجالا للتأويل بأنه لا وجود لهم، وذلك عندما أكدت أن "إسرائيل" دولة اليهود وأن لا مطالبات إضافية لأي طرف فوق ما ورد في الوثيقة.
دولة اليهود تعني أن "إسرائيل" للشعب اليهودي فقط، وأنه لا توجد قومية أخرى أو شعب آخر يشارك في هذه الدولة أو يحق له أن يدعي ذلك. هذا ما أكدت عليه الحركة الصهيونية قديماً عندما سعت إلى إقامة الوطن القومي اليهودي، وهو ما دأبت "إسرائيل" في الإصرار عليه والتمسك به. وقد أكدت دول أوروبية عديدة على يهودية "إسرائيل" وأكد عليها بوضوح الرئيس الأمريكي جورج بوش في الاحتفال الخاص بخريطة الطريق الذي أقيم في الأردن. هذا تأكيد يهدف أساساً إلى نكران حق اللاجئين في العودة وحق الفلسطينيين في الوطن المحتل 48 من المطالبة بحقوق قومية.
التمسك بيهودية "إسرائيل" عبارة عن إلغاء لكل من هو غير يهودي في فلسطين وتجريدهم من حقوقهم الوطنية والقومية والثقافية على اعتبار أن أي مطالبة تندرج في هذا الباب تعتدي على المبدأ الأساسي. وهذا يعني بالتالي أن كل من هو غير يهودي هو مجرد ساكن لا حقوق له من النواحي التنظيمية والانتمائية، ولا يحصل إلا على ما تقرر "إسرائيل" أن تمنحه إياه. التعليم والصحة والسكن، وغير ذلك ليست حقوقاً وإنما منح أو هبات تقدمها "إسرائيل" تقديراً منها لسد حاجات فردية يتم الاعتراف بها دولياً.
يشكل العرب في الوطن المحتل 48 حوالي 20% من سكان "إسرائيل"، هذا إن صدقت الإحصاءات المعلنة. هؤلاء ليسوا أقلية بسيطة، إذا جاز استعمال كلمة أقلية، وإنما يشكلون جزءاً كبيراً من السكان يسيطرون على جزء كبير من مجمل النشاطات داخل الدولة. وجودهم ملموس وحيوي في مجالات الاقتصاد والعمل والسياسة والثقافة، ومن المتوقع أن يزداد دورهم اتساعاً مع ازدياد الوعي بالذات القومية وازدياد عدد السكان. هناك زيادة مطردة بعدد السكان وازدياداً بنسبتهم في المجمل العام خاصة أن وتيرة الهجرة اليهودية إلى فلسطين تشهد ركوداً، وليس من المتوقع أن تشهد موجات مهمة جديدة في المستقبل المنظور. من حق هؤلاء أن يؤكدوا هويتهم القومية وذلك من خلال مؤسسات تخدم هذا الغرض. من المفروض أن تكون لهم أحزاب وتنظيمات قومية تبث الوعي القومي الذي يؤكد الهوية المميزة، ومن حقهم أن تكون لهم جامعات ومدارس خاصة بهم غير خاضعة لرقابة يهودية، ومؤسسات ثقافية وتراثية تؤكد الانتماء للثقافة العربية الإسلامية وأن يكون لهم علاقاتهم مع المجتمعات والدول العربية والإسلامية. مثلما يعتبر اليهود أنفسهم قومية ويقيمون المؤسسات المختلفة لتأكيدها وتجسيدها وتعميقها في النفوس والسلوك، فإن للعرب ذات الحق. وثيقة جنيف تتجاوز كل هذا وتنحاز بوضوح لصالح المشروع الصهيوني.
وتبقى المأساة العظيمة في وصف العرب بأنهم عرب "إسرائيل". هذا الوصف ينزع صفة الأصالة العربية الإسلامية عن فلسطين ويجعل من "إسرائيل" أصلاً ومن العرب شيئاً طارئاً. تؤكد التسمية أن "إسرائيل" هي الأصل وهي البوتقة الأوسع، وتوحي بأن الفلسطينيين قد هاجروا إليها أو صدف أن تواجدوا فيها. وهذه التسمية لا يتمسك بها الرسميون الفلسطينيون والعرب فقط وإنما هناك من بين الفلسطينيين في الوطن المحتل عام 48 من يسمي نفسه ب "عرب إسرائيل" بخاصة من الأحزاب التي تدافع عن حل تاريخي شبيه بحل وثيقة جنيف. هناك من بين الفلسطينيين داخل فلسطين من لا يطالب بعزة أو تحرر ويقبل بالحكم "الإسرائيلي" وبمبدأ خذ وطالب. أي أنه لا يبحث عن هوية وإنما يبحث عن امتيازات أو منح وهبات تقدمها له "إسرائيل" عبر المطالبات المتواصلة.
وثيقة جنيف تلغي حقوق خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، وتلغي مليون فلسطيني عام 1948، وتحول باقي الفلسطينيين إما إلى حراس على دولة "إسرائيل" أو إلى متهمين بالإرهاب يقوم الحراس بملاحقتهم، ومن ثم يصفها أصحابها بأنها حل تاريخي. هذا حل لا حظوظ له بالنجاح إطلاقاً، وإن بدا أنه ينجح أحياناً فإن الفشل بانتظاره. الحل التاريخي هو الذي يتماشى مع الحقيقة الموضوعية التي تفرض نفسها وليس الذي يتناسب مع معادلة القوة السائدة في مرحلة تاريخية معينة.
الحل التاريخي هو الذي يتناسب مع تطلعات العرب والمسلمين ولا يتجاوز حقوق الفلسطينيين. فمن ظن أن الحل التاريخي يتغير بتغير ظروف القوة وأوضاعها إنما يتجاهل قدرة الأمم على التغيير وإصرارها على انتزاع حقوقها. ولهذا فإن أي حل يتجاوز الحقوق إنما من شأنه أن يطيل أمد الصراع لا أن ينهيه
المشهد الخامس: جنيف وقضية اللاجئين
قد لا يكون جديداً القول ان تاريخ الصراع الفلسطيني الصهيوني مليء بالاتفاقات والتفاهمات والمشاريع والوثائق.. التي شكل كل واحد منها محطة سياسية تستهدف تصفية هذه القضية، ولكننا مع ذلك نعيش في خضم مقاومة فلسطينية اسطورية تتميز عن كل ما سبقها من مراحل الصراع والمقاومة من حيث الروح والزخم والاهداف والساحة، بل وحتى على مستوى النتائج إلى درجة ان قادة هذا الكيان اعتبروها حرباً وجودية تعددت اساليب التعبير عن ذلك من "حرب على البيت" إلى كونها امتداداً لحرب 1948.. وعلى خط موازٍ تتميز هذه الوثيقة عن كل ما سبقها من وثائق وتفاهمات ... أنها تحاول تصفية القضية الفلسطينية والالتفاف على ما استطاعت المقاومة في فلسطين ان تحققه من انجازات حيث استطاعت ان تهز اسس هذا الكيان المبنية على الامن مع ما رافق ذلك من تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية خطيرة... ـ من الواضح أن مناقشة الوثيقة من خلال مدى انسجامها مع الحق الفلسطيني يعني أن الحكم سيصدر مع بدء المحاكمة وستُختتم الجولة بالضربة القاضية التي لا حاجة بعدها إلى مواصلة العرض والمناقشة... وبخصوص تقويمها نسبة للقضايا المطروحة والتي تشكل المحاور الأساسية في هذه المرحلة: المستوطنات، القدس واللاجئون، حيث يُلاحظ أن الطرف الفلسطيني المشارك في هذه التفاهمات قد وافق على إنهاء الصراع "الفلسطيني ـ الإسرائيلي" على أساس الاعتراف بدولتين على ارض فلسطين هما "إسرائيل وفلسطين؟"، الأولى تمتد على مساحة اكثر من 78% من مساحة فلسطين التاريخية، والأخرى تُقام على ما تبقى من مساحة بقيود سياسية خانقة تُفقد هذه الدولة محتواها السيادي وكونها دولة تجسد طموحات شعب.. بل واكثر من ذلك اعتبر ذلك بمثابة طعم ووسيلة لتمرير تنازلات خطيرة أخرى تتعلق بقضيتين أساسيتين مطروحتين على الساحة هما: القدس واللاجئون.
واما بالنسبة لقضية القضايا وهي اللاجئون فلا بد من الإشارة ابتداءً أن المقاومة الفلسطينية في ظل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية (بتاريخ 1/1/1965) كانت منذ أن انطلقت (في أحد جوانبها على الأقل) هي حركة ومقاومة لاجئين من اجل عودة اللاجئين، فضلاً عن تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة (عام 1948). الا اننا نلاحظ انه لم يتم ذكر عبارة "حق العودة" حتى في سياق النفي لأن "إسرائيل" رفضت بالمطلق أن ترد هذه العبارة وبالطبع وافق المفاوض الفلسطيني على ذلك تحت عنوان الواقعية السياسية ولضرورة التوصل إلى تفاهم سياسي يُنهي الصراع.. ويلاحظ من الخيارات التي طرحت لمعالجة قضية عودة اللاجئين أن الطرق التي تم عرضها تؤدي إلى حقيقة واحدة هي عدم عودة اللاجئين، وتمت معالجة هذه المسألة بأن يختار اللاجئ مكان سكنه الدائم وفقاً للخيارات والانظمة المقررة في هذا الاتفاق على أن تكون على النحو التالي:
ـ دولة فلسطين.
ـ مناطق في "إسرائيل" تُنقل إلى فلسطين ضمن اتفاق تبادل الأراضي، بعد أن تُعلن فيها السيادة الفلسطينية.
ـ دول طرف ثالث.
- "دولة إسرائيل"، على أن يكون ذلك خاضعاً للتفكير السيادي "لاسرائيل" ويتناسب مع العدد الذي ستنقله إلى اللجنة الدولية. أي إن القرار النهائي هو بيد "إسرائيل."
ـ الدول المضيفة الحالية.
ولم يتوقف الامر على ذلك بل تم الالتفاف مسبقاً على أي محاولة مستقبلية لاعادة اثارة القضية عبر ايراد بند تحت عنوان: نهاية المطالب، يتضمن ان هذا الاتفاق هو حل كامل ودائم لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين. ويجب عدم طرح مطالب أخرى غير تلك المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق. ـ أما بخصوص مقارنة الوثيقة بما عُرض في كامب ديفيد ـ إبان المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وإبان تولي ايهود باراك لرئاسة الحكومة ـ يتبين لنا انه تم تعديل بعض النقاط في ما يخص بمستوطنة اريئيل التي اتفق ان تلحق بالدولة الفلسطينية العتيدة. كما وسيتم نقل السيادة على الحرم - على مراحل - إلى الفلسطينيين بينما ستكون السيادة على حائط البراق (حائط المبكى) لليهود، مع منح دور لقوة دولية في القدس وفي نقاط الحدود، وتمت الموافقة على أن يتم تحديد الحدود على أساس "الخط الاخضر"، مع تبادل للاراضي بنسبة 1:1 في مقابل الاراضي التي سيتم ضمها إلى الكيان الاسرائيلي.
ـ اما بخصوص موقع هذه الوثيقة من خارطة الطريق المستندة إلى ما يعرف برؤية الرئيس الاميركي بوش فإن وثيقة "جنيف" تسعى إلى حل النزاع على أساس تقسيم فلسطين إلى دولتين، وهي بالتالي تتطابق مع المبدأ الذي تضمنته رؤية الرئيس بوش (في ما يتعلق بالدولتين) ومع "خريطة الطريق". ولكن الوثيقة تتجاهل المبنى السلطوي للدولة الفلسطينية، ولا تحاول فرض ما يطلقون عليه إصلاحات شاملة. وحسب أحد المشاركين الصهاينة في هذه الصيغة، "من ناحيتي فليكن هناك نظام ديكتاتوري مثل مصر، ولكن إذا لم يعرفوا كيف يُحققون الأمن، فلن يكون هناك اتفاق".
كما ان خارطة الطريق لا تنص على كيفية معالجة القضايا العالقة بين السلطة الفلسطينية وانما يُذكر انها ستطرح في المرحلة الثالثة والاخيرة على طاولة المفاوضات بعد ان يتم سلب الطرف الفلسطيني من كل اوراق القوة في حين ان هذه الوثيقة تتضمن طرحاً تفصيلياً لحل كل قضايا الوضع النهائي.
إلا أن الحقيقة التي ستبقى تؤرق كل مخلص للقضية الفلسطينية هي هل هذه الالاف المؤلفة من الشهداء والجرحى والمعوّقين والأسرى (التي سقطت خلال ثلاث سنوات من الانتفاضة على الاقل) وهل هذا التدمير الذي لحق بالبنية التحتية للشعب الفلسطيني ثمنه هو أن يتنازل الصهاينة عن مستوطنة ارييل التي رفضوا التنازل عنها في كامب ديفيد، ومن اجل ايجاد تواصل جغرافي بين بقعة جغرافية هنا وبقعة هناك، ومن اجل تقسيم القدس الشرقية بين الفلسطينيين والصهاينة والاعتراف الصهيوني المُمرحل بالسيادة على الحرم، في مقابل تخلي فلسطين عن حائط البراق؟؟ وان يتم توطين وتشتيت اللاجئين الفلسطينيين في شتى انحاء العالم، ويتم تكريس الاحتلال الصهيوني لباقي اراضي فلسطين التاريخية.
نعم، ما يمكن قوله ان هذه المواقف المتعلقة ببعض الانسحابات والاعتراف بالسيادة الفلسطينية على الحرم، انتزعت بفعل المقاومة، ولكن اقترانها بتنازلات تاريخية ومصيرية سيحولها من انجازات إلى مشروع نكبة اكبر من النكبة الأولى. وما سيُعتبر إنجازا وتقدما على هذا الصعيد يكون قد فقد روحه وأبعاده الإيجابية لأنه قُدِّم كتبرير وواجهة لتضييع حقوق اللاجئين وللتخلي عن حقنا في باقي فلسطين..
المشهد السادس :جنيف وقضية الأسرى
من مؤشرات افتقاد الموضوعية فيما يسمى "اتفاق جنيف" عدم استشارة الفلسطينيين أصحاب الشأن في كل قضية تناولها، وإنما اتخاذ القرار بشأنهم من وراء ظهورهم. كذلك كان الأمر بالنسبة للاجئين وأهالي القدس خاصة، والشعب العربي الفلسطيني بشكل عام. وهو كذلك في قضية الأسرى العرب القابعين وراء قضبان المعتقلات الصهيونية، خاصة قادة الرأي وذوي الخبرة منهم المحتجزين في زنزانات انفرادية مطلية الجدران باللون الأسود لإحكام عزلتهم عن دنيا الأحياء. إذ تفرد بتقرير مصيرهم الذين التقوا في فندق سياحي بخمسة نجوم على شاطئ البحر الميت في جانبه الأردني. كما ورد نصا في بيان "إعلان المبادئ" الذي وقعوه بالأحرف الأولى.
وبالعودة للبند 15 من "إعلان المبادئ" ورد تحت عنوان "السجناء والمعتقلون الفلسطينيون" ما نصه: في سياق هذا الاتفاق الدائم بين "إسرائيل" وفلسطين، نهاية النزاع، وقف كل العنف، وترتيبات الأمن المشددة المقررة في هذا الاتفاق، فإن كل السجناء الفلسطينيين والعرب المعتقلين في إطار النزاع "الإسرائيلي" الفلسطيني في موعد التوقيع على هذا الاتفاق في عام 2003 سوف يفرج عنهم وفقاً للتصنيفات التي تتقرر فيما يلي وتفصل بالملحق بالاتفاق: 1 أ، الصنف (أ) كل الأشخاص الذين سجنوا قبل بدء تطبيق إعلان المبادئ في 4 مايو/أيار 1994 المقصود بذلك بدء العمل باتفاق أوسلو، المعتقلون الإداريون والقاصرون، وكذا النساء والسجناء المرضى يفرج عنهم فوراً مع دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
1 ب، الصنف (ب) كل الأشخاص الذين سجنوا بعد 4 مايو/أيار 1994 وقبل التوقيع على هذا الاتفاق يفرج عنهم في موعد لا يتجاوز 18 شهراً بعد موعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، باستثناء أولئك المشار إليهم في الصنف (ج). 1 ج، الصنف (ج) حالات استثنائية، أشخاص أسماؤهم مفصلة في ملحق الاتفاق، يفرج عنهم في غضون ثلاثين شهراً بعد نهاية التطبيق الكامل للجوانب الإقليمية من هذا الاتفاق.
والنص السابق لا يختلف في شيء عما كان قد تضمنه اتفاق أوسلو قبل عشر سنوات في موضوع الأسرى والمعتقلين من حيث تصنيفهم إلى فئات، والتمييز فيما بينهم في عملية إطلاق سراحهم، المتفق أن تتم على دفعات وفقاً لبرنامج المتحكم في تنفيذه الطرف الصهيوني، بدليل أنه لما يزل هناك أسرى يعود اعتقالهم إلى ما قبل الرابع من مايو/أيار 1994. وحين يقرأ ما ارتضاه ياسر عبدربه ورفاقه بالنسبة للمعتقلين من أبناء شعبهم وأمتهم يتضح أن ما أقدموا عليه ليس له مثيل في كل تجارب حركات التحرر الوطني في العصر الحديث، كما أن له دلالته على الاتفاق بمجمله وقناعة الفريق الذي وقع عليه ومن أيدوه سراً وعلانية.
وفي قراءة النص في ضوء التجارب الإنسانية لن نغوص في صفحات التاريخ، وحسبنا الإشارة إلى حالتين قريبتي العهد وثالثة معاصرة. فعندما فشل بطل فرنسا التاريخي الجنرال ديجول في قمع ثورة الجزائر، واضطر إلى الدخول في "سلام الشجعان" الذي يحلو للرئيس عرفات تشبيه اتفاق أوسلو البائس به أصرت قيادة الثورة في الخارج أن يكون الحوار مع أحمد بن بيلا ورفاقه المعتقلين في فرنسا، وأن ينقل المعتقلون للحدود السويسرية كي يتم التواصل الحر معهم. وعندما وقع الاتفاق لم يتبق في السجون الفرنسية أسير واحد، إذ لم يخضع موضوع الأسرى لمنطق المساومة أو يتأثر بالنزاعات المحتدمة بين قادة الثورة.
وعندما توصل العنصريون البيض في جنوب أفريقيا، تحت ضغط كفاح "المؤتمر الوطني الأفريقي" والرأي العام العالمي، إلى حتمية الحوار مع نلسون مانديلا ورفاقه أصر الزعيم الأفريقي، الذي كان قد أمضى في سجون العنصريين سبعة وعشرين عاماً، أن يكون آخر من يغادر السجن من المناضلين الأفارقة، وذلك ما تم فعلاً نتيجة التزام الزعيم الأفريقي بالوفاء لجميع المناضلين الذين أسهموا في صناعة الانتصار التاريخي.
واليوم يضرب حسن نصرالله، وقيادة حزب الله، مثالاً للالتزام الأخلاقي والوفاء الوطني، بالإصرار على أن يكون المناضل سمير قنطار في مقدمة المفرج عنهم من الأسرى العرب. علما بأنه حين وقع سمير قنطار في الأسر كان عضواً في منظمة يسارية فلسطينية، ولم يكن حزب الله قد برز للوجود، ولا عرف عن سمير قنطار ولاؤه لحسن نصرالله وإخوانه في قيادة حزب الله.
وعلى خلاف تجارب حركات التحرر الوطني في العالم الثالث، والعربية من بينها، قبل ياسر عبدربه ورفاقه، ومن يمثلونهم ويعبرون عنهم، الاشتراطات الصهيونية، جرياً على عادتهم في تقديم التنازلات، بدلاً من الإصرار على إطلاق الأسرى جميعاً ومن دون استثناء، كشرط يسبق التنفيذ للتأكد من مدى التزام الصهاينة بما اتفقوا عليه، نتيجة ما عرفوا به من عدم الوفاء بأي استحقاق ينتقص من مكاسبهم. وفي ذلك مؤشر على أن "إعلان المبادئ" الذي جرى توقيعه بالأحرف الأولى في لقاء البحر الميت ليس إلا إعادة إنتاج لاتفاق أوسلو، برغم اختلاف الظروف فلسطينياً وإسرائيلياً" ودولياً عما كانت عليه عندما وقع الاتفاق سيئ السمعة. ولقد توالت خلال الأسابيع القليلة الماضية تصريحات الرئيس عرفات، وشركائه في صناعة قرار السلطة الفلسطينية، الموافقة ضمناً على ما احتواه ما يسمى "اتفاق جنيف"، ومن بينها إرجاء إطلاق سراح المناضلين الذين لولا أداؤهم البطولي ومعاناة ذويهم ما كان عهد تفرق الرئيس وصحبه في المنافي العربية قد انتهى، ولا كان قد بدأ زمن تربعهم في كراسي السلطة، وتمتعهم بالمناصب والألقاب الرسمية، وتنامي ثروات أصحاب الحظوة منهم، وحيازتهم بطاقات الصفوة VIP. ولا يقف الأمر عند خروج الرئيس وصحبه على ما اعتادته قيادات حركات التحرر الوطني من الوفاء لرفاق الدرب وعدم التهاون في المسائل المبدئية، وإنما فيه أيضاً الدلالة القاطعة على أن الفئة المتفردة بصناعة القرار الفلسطيني لما تزل أسيرة نهج أوسلو وما يتسم به من عجز عن قراءة معطيات الواقع بموضوعية، وبخاصة تأثير أداء المقاومة الفلسطينية في الساحة "الإسرائيلية". والقصور بالتالي عن توظيف الإبداع الفلسطيني في تحقيق مكاسب وطنية. بل وتحول التناقضات مع التحالف الإمبريالي الصهيوني إلى تناقضات غير عدائية لا تحتم الصدام، نتيجة تقديم المصالح الذاتية على الحقوق الوطنية والثوابت القومية. وحين يرتضي الفريق الفلسطيني في لقاء البحر الميت، التصنيف الصهيوني للأسرى، ورهن الإفراج عن "الصنف ج" إلى ما بعد التطبيق الكامل للجوانب الإقليمية مما يسمى "اتفاق جنيف"، ففي ذلك دلالة مؤكدة على أن توفير "الأمن" الصهيوني بات في مقدمات الاستحقاقات الملزمة للسلطة الفلسطينية وأجهزتها، الأمر الذي يعني في التحليل الأخير تراجع التناقضات مع التحالف الأمريكي- الصهيوني إلى أن تغدو ثانوية، وذلك في مقابل نمو التناقضات لتصبح عدائية تحتم الصدام مع أبناء شعبهم الفلسطيني وأمتهم العربية الملتزمين بالمقاومة خياراً استراتيجياً.
وعلى الرغم من خطورة كل ما احتواه "اتفاق جنيف" على الثوابت الوطنية والقومية إلا أن "ترتيبات الأمن المشددة المقررة" فيه، وما نص عليه تحت عنوان "السجناء والمعتقلون" هو الأخطر والأدعى للتنبه والمواجهة، لأن تصفية الاحتلال هي المقدمة الطبيعية لإقامة الدولة كاملة السيادة، واستعادة كامل الحقوق الوطنية المشروعة. وتصفية الاحتلال مستحيلة في حال تفجر الصراع مع قوى المقاومة، والتصدي لها بدلاً عن الالتفاف من حول رموزها الوطنية والإسلامية ورفدها بكل القدرات والإمكانيات المتاحة. وذلك هو التحدي الذي يواجه مختلف قوى الشعب العربي الفلسطيني في الوطن المحتل وفي الشتات.
المشهد السابع : جنيف وقضية القدس
في الوقت الذي تجاهلت فيه خطة الطريق قضية القدس وفضلت عدم التطرق إلى مقترحات محددة بشأنها تحت رعاية اللجنة الرباعية ( الولايات المتحدة -الاتحاد الروسي - الاتحاد الأوروبي- الأمم المتحدة) فإن وثيقة جنيف خاطرت بالدخول إلى عش الدبابير وقدمت اقتراحات تفصيلية بشأن القدس ومختلف القضايا التي كانت تصنف بقضايا التسوية النهائية وأبرزها قضايا حقوق اللاجئين أو حق العودة والتعويض والمياه والحدود... الخ ويهمنا هنا طرح (سيناريو القدس في وثيقة جنيف) وهل أخذ السيناريو في حسبانه الدروس المستفادة من المواجهة الساخنة التي وقعت بشأن المدينة المقدسة في محادثات كامب ديفيد(2) خلال يوليو 2000 بوساطة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون؟ وأسفرت عن رفض فلسطيني شديد رغم الزعم بتنازلات غير مسبوقة من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي باراك بشأن سقف المطالب الإسرائيلية في القدس. نتناول أولاً دروس كامب ديفيد(2) من خلال عرض الأفكار التي اقترحها كلينتون والرد الفلسطيني الرافض لها ثم نعرض للإشارات السريعة التي أوردتها خريطة الطريق بشأن القدس، وتخوف الخريطة من الانزلاق إلى تسجيل أن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية التي بشرت بقيامها عام 2005، وبعد ذلك نعرض سيناريو القدس كما قدمته وثيقة جنيف بتفصيلات أكثر من خريطة الطريق.
وبشأن التحفظات الفلسطينية تجاه مقترحات الرئيس كلينتون بخصوص القدس سجل المفاوض الفلسطيني في بداية يناير2001 عدة ملاحظات عليها كما يلي: في موضوع القدس اقترح الرئيس كلينتون المبدأ العام بأن المناطق العربية ستكون لفلسطين والمناطق اليهودية ستئول إلى "إسرائيل" ولكنه ناشد الطرفين العمل على خرائط توجد الحد الأقصى من التوصل الجغرافي لكليهما، وتم تقديم صياغتين محتملتين فيما يتعلق بسيادة وحقوق كل من الجانبين على الحرم الشريف، والجدار الغربي، وتتكلم كل من الصياغتين حول السيادة الفلسطينية على الحرم الشريف والسيادة الإسرائيلية على الحائط الغربي، مع الحد من صلاحيات الجانبين بالحفر، والتنقيب تحت الحرم أو وراء الحائط.
إن الصياغتين الأمريكيتين حول الحرم تطرحان عدداً من الإشكاليات.
يبدو أن المقترح الأمريكي يعترف ضمناً بالسيادة الإسرائيلية تحت الحر م حيث يلمح أن لإسرائيل الحق بالحفر خلف الحائط (وهي ذات المنطقة التي تقع تحت الحرم) ولكنها تتخلى طواعية عن هذا الحق كما أن مصطلح الحائط الغربي يمتد إلى منطقة تتعدى الحائط الغربي، وتضم النفق الذي فتحه رئيس وزراء "إسرائيل" الأسبق نتنياهو عام 1996 والذي أدى إلى مواجهات واسعة النطاق.
إن الجانب المتعلق بالأرض في المقترح الأمريكي حول القدس يطرح عدداً من الإشكاليات ويتطلب مزيداً من التوضيح.
كما توضح الخريطة فإنه وكنتيجة للسياسة الاستيطانية الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة تلك السياسة التي حازت على شجب عالمي فإن المقترح الأمريكي بأن المناطق العربية ستكون لفلسطين والمناطق اليهودية ستئول إلى "إسرائيل" لا يمكن توفيقه مع مبدأ الحد الأقصى من التواصل الجغرافي للجانبين والذي طرح في ذات المقترح لأن هذه الصيغة ستؤدي في نهاية المطاف إلى جزر فلسطينية متقطعة داخل المدينة، بينما ستتمكن "إسرائيل" من المحافظة على تواصلها الجغرافي، وعليه فإن المقترح الحد الأقصى من التواصل الجغرافي للجانبين سيترجم في الواقع إلى الحد الأقصى من التواصل الجغرافي لإسرائيل. إن استمرار "إسرائيل" بالمطالبة بالسيادة على عدد من المواقع الدينية غير المحددة جغرافيا في القدس، ورفضها المستمر تقديم خرائط توضح مطالبها في القدس إنما يعززان من المخاوف الفلسطينية أن أي حل مقبول فلسطينياً يجب أن يضمن التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية في القدس من جهة، وبين القدس وبنية الأراضي الفلسطينية من جهة أخرى.
إن أحد العناصر الأساسية للموقف الفلسطيني حول القدس يتعلق بمكانتها كمدينة مفتوحة مع ضمان حرية الجميع في الوصول إليها. إن هذه المكانة أساسية ليس فقط لضمان حرية الوصول إلى مواقع العبادة في جميع الأماكن المقدسة لكل مؤمن بقداسة المدينة، ولكنها أيضاً في غاية الأهمية لضمان التواصل وحرية الحركة ضمن الدولة الفلسطينية وللأسف، فإن العرض الأمريكي لا يشير إلى هذا المبدأ. هذا عن الموقف الفلسطيني الرافض لأية تنازلات أساسية تمس عروبة القدس الشرقية، أما بشأن خريطة الطريق فلم تشير إلى وضع القدس إلا في ثلاث فقرات سريعة وردت في سياق المرحلتين الثانية والثالثة بينما تجاهلت ديباجة خريطة الطريق والمرحلة الأولى الإشارة إلى القدس من قريب أو بعيد. وبشأن ما جاء بالمرحلة الثانية بشأن القدس فقد أشارت الترتيبات التي وضعتها هذه المرحلة لبناء المؤسسات الفلسطينية بإيجاز شديد إلى المؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس الشرقية وطالبت الحكومة الإسرائيلية بإعادة افتتاح الغرفة التجارية الفلسطينية وغيرها من المؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس بناء على التزام بأن هذه المؤسسات تعمل بشكل تام وفقاً للاتفاقيات السابقة بين الطرفين.
ولعل هذا النص يوحي بأن خريطة الطريق لا تريد تسييس عمل تلك المؤسسات وفي مقدمتها بيت الشرق الذي كان بمثابة وزارة للشئون الخارجية الفلسطينية. أما ما جاء في سياق المرحلة الثالثة من خريطة الطريق بشأن القدس فلم يقدم مقترحات بشأن مستقبل المدينة بل قام بترحيل القضية برمتها - كما فعلت أوسلو(1) من قبل عام 1993- إلى مؤتمر دولي تعقده المجموعة الرباعية بالتشاور مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي مطلع عام 2004 للمصادقة على اتفاق يتم التوصل إليه يؤدي إلى حل دائم لقضايا الوضع الدائم في عام 2005 بما في ذلك الحدود، والقدس واللاجئين، والمستوطنات ثم عادت خريطة الطريق وأشارت إلى المعالم الرئيسية لسيناريو الحل المتوقع للقدس الذي يأخذ بعين الاعتبار الاهتمامات السياسية، والدينية للجانبين، ويصون المصالح الدينية لليهود والمسيحيين والمسلمين على صعيد العالم ويحقق رؤيتي دولتين، "إسرائيل"، ودولة ذات سيادة مستقلة ديمقراطية وقابلة للحياة هي فلسطين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن يعني هذا أن خريطة الطريق نهجت نهج أوسلو(1) في عملية الترحيل للقضايا الشائكة بينما وثيقة جنيف آثرت تسجيل مقترحاتها بشأن القدس جنباً إلى جنب مقترحاتها بشأن القضايا الشائكة الأخرى وكأنها حزمة واحدة كما يلي:
قيام دولة فلسطينية بجوار "إسرائيل" على الأراضي الفلسطينية ما قبل الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967 وتتعهد "إسرائيل" بالانسحاب من الأراضي المحتلة على مراحل في غضون 30 شهراً من تطبيق الاتفاق، ويتفق الجانبان على بعض التعديلات بالنسبة لحدود 1967 ( الخط الأخضر).
تتبادل الدولتان التمثيل الدبلوماسي والقنصلي الكامل بمجرد الإعلان المتبادل والمتزامن عن اعترافهما بحق وجود الآخر.
تحتفظ الدولتان - فلسطين - و"إسرائيل" - بعاصمتيهما في المناطق الخاضعة لسيادتيهما من مدينة القدس، ويعني ذلك قيام العاصمة الفلسطينية في القدس العتيقة (الشرقية) ويستثني الحي اليهودي وحائط البراق (المبكى) من السيادة الفلسطينية.
تحتفظ قوات الأمن الإسرائيلية بحق التمركز والحراسة في تجمع مستعمرات جوش عتصيون في جنوبي الضفة الغربية، وفي ضواحي مدينة القدس، وتضم مستعمرات: أرييل، وعفرات، وجبل أبو غنيم إلى الدولة الفلسطينية الوليدة.
تتنازل "إسرائيل" عن حق السيطرة على مناطق في صحراء النقب تتاخم قطاع غزة مقابل مناطق بالضفة الغربية تخضع حاليا للفلسطينيين، أو تمثل حقاً لهم. تقيم الدولتان ممراً يربط الضفة الغربية بقطاع غزة على أن يخضع الممر للسيادة الإسرائيلية، ويديره الفلسطينيون. ويبدو واضحاً أن وثيقة جنيف التي جاءت في أكثر من 50 صفحة وبتفصيلات دقيقة للقضايا الخلافية تعد مسودة اتفاقية للوضع الدائم التي طالبت خريطة الطريق بعقد مؤتمر دولي لوضعها عام 2004 وتحقيقها على قيام الدولة الفلسطينية عام 2005، ويعني هذا أن وثيقة جنيف قد اختصرت مشواراً طويلاً من المفاوضات في ظل خريطة الطريق لوضع مثل هذه المعركة، وما يهمنا واقع ومستقبل القدس.. وهي القضية التي تحطمت عليها محادثات كامب ديفيد(2) (يوليو2000 - يناير2001) فهل يتكرر الفشل مرة أخرى أمام الثوابت الفلسطينية أو الخطوط الحمراء الفلسطينية بشأن عروبة القدس الشرقية؟ ولعل الإجابة عن هذا التساؤل تتطلب إعادة قراءة لوثيقة جنيف؟!
المشهد الثامن :جنيف وقضية القدس(2) لم يتبنّ رسمياً أي طرف فلسطيني وثيقة جنيف وذلك لأسباب عدة منها أن الوثيقة حلت قضية القدس على أساس أن الحي اليهودي لليهود، والحي العربي للعرب، وأن الحرم القدسي يبقى تحت السيادة الفلسطينية، مع إبقاء حائط المبكى حائط البراق تحت السيادة الإسرائيلية. أما المدينة القديمة فتبقى في إطار دولي. ولم تشرح الوثيقة ماذا تعني ببقاء المدينة القديمة في إطار دولي. فهل تعني الوثيقة ما ورد في قرار التقسيم الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29/11/1947 برقم 181 والذي جعل مدينة القدس كياناً منفصلاً خاضعاً لنظام دولي خاص، أم هل تعني أن القدس هي العاصمة الأبدية لإسرائيل وفق قرار الكنيست، أم أنها عاصمة لفلسطين و"إسرائيل" معاً؟ بيد أن الوثيقة قسمت المدينة إلى حيين عربـي ويهودي، دون أن تشير إلى الانسحاب من المدينة العربية التي احتلتها "إسرائيـل" في حرب 1967. وبخاصة أن الطرف الإسرائيلي لم يأخذ على محمل الجد قط الانسحاب إلى حدود 1967 حتى الآن. ويبدو أن الطرف الفلسطيني المفاوض من أجل وثيقة جنيف التي تمّ إعدادها على البحر الميت نسي أن هناك لجنة إسلامية اسمها لجنة القدس يرأسها ملك المغرب. وقد أسست منظمة المؤتمر الإسلامي هذه اللجنة من أجل تحرير القدس وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل 1967. لهذا وصمت الوثيقة بأنها مناورة تهدف إلى الغموض البناء الذي اتصف به أهل اليسار الإسرائيلي الذين كانوا في الحكم في "إسرائيل" وما فعلوه هو خلق الوقائع على الأرض، وإقامة المستعمرات. لهذا من الطبيعي أن يوصم الطرف الإسرائيلي الذي اشترك في إعداد هذه الوثيقة بأنه يبغي تضليل الرأي العام في "إسرائيل". إن قضية القدس تخص كل مسلم في العالم. لهذا كان على الطرف الفلسطيني المشارك أن يأخذ قرارات المنظمة واللجنة بعين الاعتبار. وهذا ما يفسر بيان القوى الوطنيــة والإسلامية الذي اتخذ موقفاً عنيفاً ضد الوثيقة وضد من وقّعها. أما قادة فتح، فقد تنصلوا من الوثيقة وقالوا إنها تعبر فقط عن وجهة نظر من وقعوها، ولا تلزم الشعب الفلسطيني ولا تتوافق مع إرادته ولا تصلح أساساً لحلّ قضيته الوطنية. خشية أهل فلسطين هي أن هذه الوثيقة قد تصبح سقفاً للموقف الفلسطيني، في حين أن بعض قادة الصهيونية، وعلى رأسهم جابوتنسكي وشامير وشارون قد أصروا على احتلال مدينة القدس وجعلها عاصمة "إسرائيل" الأبدية -حسب أقوالهم- لهذا نجد أرييل شارون أكثرهم الآن طمعاً في تهويد القدس، إلى جانب أنه يعمل من أجل إعادة الاحتلال للضفة الغربية وقطاع غزة، وهو احتلال يهدف من جرائه أن يقضي على الإرهاب الذي هو المقاومة الوطنية الفلسطينية نفسها، فيرضي معلمه الرئيس الأميركي جورج بوش الابن، كما يبغي كسر إرادة الشعب الفلسطيني وإذلاله وخلق الظروف والشروط التي تساعد شارون على ترحيل الشعب الفلسطيني عن وطنه. إنه يعيد إلى الأذهان لجوء عام 1948 و يريد تكراره طوعاً أو كرهاً.
يُخشى أن تكون وثيقة جنيف وسيلة لإيقاف الانتفاضة التي يسعى شارون إلى وقفها إضافة إلى فرض شرط التنازل الإسلامي والعربي عن القدس تنازلاً نهائياً. لذلك جعلتها خريطة الطريق- المشروع الأميركي الذي يعاني الآن سكرات الموت بفعل شارون وإرادته من موضوعات المرحلة النهائية. ومن هنا اعتبرت وثيقة جنيف مكملة لخريطة الطريق وشارحة لها وحالّة لبعض القضايا التي جعلتها خريطة الطريق في المرحلة النهائية منها. وليس خافياً أن الولايات المتحدة قد أيدت -يومذاك- قرار التقسيم 181 وهي تسلح "إسرائيل" وتنقذها في ما تعانيه من القضية الفلسطينية. ويبدو أنها مستعدة للموافقة على وثيقة جنيف بعد أن امتدحها وزير الخارجية الأميركي. ولكن الإدارة الأميركية تشترط موافقة الحكومة الإسرائيلية على الوثيقة حتى تسحب تلك الإدارة مشروع خريطة الطريق الذي يمثل الإدارة الدولية أو الأغلبية الدولية، بخاصة بعد أن استصدرت روسيا الاتحادية من مجلس الأمن قراراً خاصاً باعتبار خريطة الطريق حلاً للقضية الفلسطينية.
المشهد التاسع : سويسرا ووثيقة جنيف: تقويض سيادة القانون يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدّة مشاركة سويسرا في ما يسمى "وثيقة جنيف"[1] وموافقتها عليها. ويؤكّد المركز على أن تأييد سويسرا لوثيقة جنيف يتعارض مع واجباتها كدولة مودعة لديها اتفاقيات جنيف[2] وكطرف سامٍ متعاقد على اتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949 (اتفاقية جنيف الرابعة). وثيقة جنيف والقانون الدولي الإنساني "وثيقة جنيف" هي "مقترح للسلام" غير رسمي صاغته وتبنّته مجموعة من الشخصيات الفلسطينية والإسرائيلية[3] برعاية وزارة الخارجية السويسرية، وقد أصدرت في شهر أكتوبر 2003 وقدّمت على أنها "تحقيق للسلام في الوضع النهائي حسب التصور الموجود في عملية خارطة الطريق التي ترعاها اللجنة الرباعية".[4] وتهدف الوثيقة إلى وضع رؤية مفصّلة وشاملة لـ "الحلول الوسط" المطلوبة[5] من أجل تحقيق "المصالحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين."[6] وقد تم تسويق وثيقة جنيف على أنها "اختراق" قي مفاوضات السلام، ولكن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يؤكّد بأن "توصيات" الوثيقة تشكّل تقويضاً غير شرعي للحقوق الأساسية الفردية والجماعية للفلسطينيين، وتمسّ بسيادة القانون من خلال المراوغة حول التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة.
إن وثيقة جنيف، في تعارض مباشر مع روح ونصوص القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة،[7] لا تطلب من إسرائيل أن تتخلّى عن كافة الأراضي التي تمّت مصادرتها من أجل النشاط الاستيطاني، وأن تسحب جميع المستوطنين اليهود وقوات الاحتلال من الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أن نموذج "الدولة" الفلسطينية المستقبلية الذي ترتئيه وثيقة جنيف يسمح بمواصلة انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة، منكرة حق الفلسطينيين في تقرير المصير والدفاع عن النفس،[8] وتلغي الحقوق الأساسية لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني من خلال منح حكومة إسرائيل القدرة على الاعتراض على أي أو كل المطالب من اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم في ما هي الآن مناطق إسرائيل.[9] ولم تكتف وثيقة جنيف بعدم محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب المنظمة وواسعة النطاق التي تقترفها يومياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل إنها تحاول أيضاً خلق عملية تشريع، يصبح من خلالها الاستعمار الإسرائيلي، ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وحرمان السكان الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير باستخدام القوة الحربية ترتيباً دائماً تحت ستار اتفاق "قانوني" حول الوضع النهائي. دور سويسرا في تقويض القانون الدولي الإنساني تقع على عاتق سويسرا مسئوليات محدّدة كطرف سامٍ متعاقد على اتفاقية جنيف الرابعة أو كدولة مودعة لديها اتفاقيات جنيف. كطرف سامٍ متعاقد، يقع على عاتق سويسرا التزام واضح بـ "ضمان احترام الاتفاقية في كافة الظروف" (المادة الأولى) وبشكل محدّد "ملاحقة المسئولين عن اقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية" (المادة 146). إن إيداع اتفاقيات جنيف لدى سويسرا يضع على عاتقها مسئوليات خاصة، من ضمنها مسئوليات إدارية: 1) تسجيل المعاهدات لدى الأمم المتحدة، 2) ترتيب إعداد وإنجاز ترجمات رسمية للمعاهدات، 3) إرسال ترجمات رسمية ونسخ معتمدة من المعاهدات إلى الأطراف السامية المتعاقدة و"أطراف النزاع".[10] لقد أخفقت سويسرا بصورة مستمرة في الوفاء بمسئولياتها كدولة مودعة لديها اتفاقيات جنيف، وطرف سامٍ متعاقد على اتفاقية جنيف الرابعة، ومن ضمن ذلك الالتزام الواضح بمحاسبة إسرائيل على الانتهاكات الخطيرة لاتفاقية جنيف الرابعة التي تقترفها بصورة مستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إن هذا التقصير الكامل في محاسبة إسرائيل على أفعالها كان واضحاً خلال مؤتمري الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة اللذين عقدا بتاريخ 15 يوليو 1999 ثم بتاريخ 5 ديسمبر 2001. عقد المؤتمران وفقاً لقرارات صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو إلى عقد مؤتمر من أجل مناقشة اتّخاذ إجراءات إنفاذ عملية لإجبار إسرائيل على وقف الانتهاكات لاتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأخفق المؤتمران في تحقيق الهدف الأساسي منهما، وأظهرا أيضاً عدم جاهزية سويسرا لاستخدام موقعها القيادي من أجل ضمان تبني آليات إنفاذ ذات مغزى، بل في الواقع، فسّر كثيرون العملية والطريقة التي نظّمت وعقدت فيها سويسرا المؤتمرين على أنها كانت رغبة من جانبها باستخدام مكانتها من أجل تقويض الهدف من المؤتمر.[11] يؤكّد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأن تأييد سويسرا لوثيقة جنيف يتعارض مع التزامها القانوني لإنفاذ أحكام اتفاقية جنيف الرابعة. ويؤكّد المركز أيضاً بأن هذا التأييد يشكّل تحوّلاً كاملاً في سياسة حكومة سويسرا من تقبّل انتزاع الأراضي بشكل غير قانوني، ونقل السكان، والانتهاكات المنظمة للحقوق الفلسطينية التي تقترفها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى تبني حقيقي وعملية تشريع لهذه الأساليب، وهو ما يشكّل مخالفة فعلية لالتزامها باحترام الاتفاقية.[12] علاوة على ذلك، حسب مبدأ حسن النوايا الواضح في المادة 26 من اتفاقية فينا حول قانون المعاهدات[13]، يعتقد المركز الفلسطيني بأن مكانة سويسرا المميّزة كدولة مودعة لديها اتفاقية جنيف تتطلّب مسئولية بوضع معايير حسنة الصيت حول ممارسة الدولة التي تدعم وتعزّز القانون الدولي الإنساني. بالتالي، فإن تأييد وتبني الدولة المودعة لديها اتفاقيات جنيف وطرف سامٍ متعاقد على هذه الاتفاقيات لـ "اقتراح" يتعارض بشكل صارخ مع نص وروح اتفاقية جنيف الرابعة، والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني، فقط يؤدّي إلى تقويض وإزالة المعايير التي يتضمنها قانون النزاعات المسلحة، ويشجّع إسرائيل على اقتراف المزيد من الانتهاكات للاتفاقية. يصرّ المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أن سويسرا، كطرف سامً متعاقد ولمكانتها كدولة مودعة لديها اتفاقيات جنيف، عليها التزام واضح بضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالتعاون مع الحكومات الأخرى، حتى كأساس لأية مفاوضات من أجل تحقيق السلام. بالتالي، فإن تأييد سويسرا لوثيقة جنيف، التي هي عبارة عن مبادرة غير حكومية تتجاهل القانون الدولي الإنساني، يتعارض مع هذه الالتزامات. وبذلك أسهمت تصرّفات سويسرا في تقويض سيادة القانون بتشجيع الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة على تجاهل التزامها التعاقدي بضمان احترام الاتفاقية. التاريخ: 13 نوفمبر 2003 [1] يشار إليها أيضاً باسم "مبادرة جنيف". [2] اتفاقيات جنيف المؤرّخة في 12 أغسطس 1949: - اتفاقية حنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان - اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار - اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب - اتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب [3] كان وزير العدل الإسرائيلي السابق يوسي بيلين، ووزير الإعلام الفلسطيني السابق ياسر عبدربه هما الشخصيتين الرئيسيتين في صياغة الوثيقة. [4] وثيقة جنيف، الديباجة، الفقرة.11 [5] وثيقة جنيف، الديباجة، الفقرة 3. [6] وثيقة جنيف، الديباجة، الفقرة 12. [7] راجع على سبيل المثال اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 49، الفقرة 6، التي تحظر نقل السكّان إلى الأراضي المحتلة، وهو ما يعتبر جريمة حرب حسب البروتوكول الإضافي الأول، المادة 85(4)(أ)؛ والمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادتين 46 و55 من القواعد الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة فيما يتعلّق بقوانين وأعراف الحرب على الأرض لعام 1907 (قواعد لاهاي)، والتي تحظر مصادرة الأراضي المحتلة من قبل قوة الاحتلال، وهو ما يعتبر جريمة حرب أيضاً حسب المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول. راجع أيضاً اتفاقية جنيف الرابعة، المادتين 27 و47 التي تحمي الحقوق الأساسية للأشخاص المحميين في الإقليم المحتل؛ واتفاقية جنيف الثالثة، المادة 4، والبرتوكول الإضافي الأول، المواد 43، و44، و48، التي تنص على الحق في المقاومة والدفاع عن النفس في وجه الغزو. [8] حسب وثيقة جنيف، فإن "دولة" فلسطين المستقبلية ستكون ممنوعة من تشكيل جيش للدفاع في مواجهة الاعتداءات الخارجية [المادة 5(3)]، ولن تكون لها سيادة أو سيطرة على مجالها الجوي وحدودها [المادة 5(9)(ب) والمادة 5(12)(ج)]. علاوة على ذلك، تسمح ترتيبات جنيف بتواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي وأفراد مخابراتها بشكل دائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع تمتّعها بالقدرة على القيام بعمليات عسكري [المادة 5(7)(و) والمادة 5(8)(أ)(و)]. وأكثر من ذلك، لا تضع وثيقة جنيف نهاية للاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية، بدلاً من السيطرة الإسرائيلية، ستأتي "قوة متعددة الجنسيات" تقودها على الأرجح الولايات المتحدة لتقوم مقام قوة الاحتلال، ويمكن سحبها فقط بموافقة إسرائيلية [المادة 5(6)(أ)(ج)(و)]. [9] راجع وثيقة جنيف، المادة 7. [10] للحصول على قائمة شاملة تتضمّن مقالات تحدّد هذه المسئوليات راجع: فلاديمير سوفت، وج. أشلي روتش، فهرس القانون الدولي الإنساني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 1987. [11] راجع "ورقة موقف للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وجمعية القانون حول مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة"، 22 نوفمبر 2001،www.pchrgaza.org . [12] اتفاقية جنيف الرابعة، المادة الأولى. [13] المادة 26 – "حسن النوايا: كل معاهدة ملزمة لأطرافها ويجب تطبيقها بإخلاص."
|
||||||||||||||||